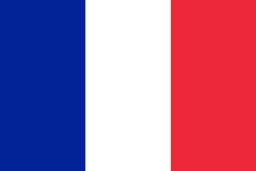Stand:
باك للعماره
Stand:
باك للعماره
في عالمنا المعاصر ، يكفي أن نعرف أن البناء في المدن يتم تحديده من خلال الإجراءات التكنوقراطية والمكاتب والخطط ، دون مراعاة ، على الأقل ، الطريقة التي يتعامل بها البشر مع الأشياء - من خلال تاريخهم ، من خلال لغة جسدهم- لفهم ضائقة مدننا وهندستها المعمارية.
علاوة على ذلك ، لا شيء يظهره أفضل من انعكاسه على المنزل وطريقة بنائه. عارض هايدجر ، بحق ، مؤيدي ميثاق أثينا ، بأن المنزل ليس "وعاءًا بسيطًا للعيش فيه". اليوم ، نرى هذا الحلم التقني للبيت الآلي يزدهر مرة أخرى من خلال الإسكان الإيكولوجي ، الذي نفكر فيه بشكل منهجي كمكان لتداول الطاقات: حل محسوب جيدًا للمشاكل البيئية. ومع ذلك ، يمكن للمنزل أن يكون بالفعل آلة معيشة ناجحة للغاية ، ويمكن أن يكون ملجأ متطورًا ومريحًا للغاية ، دون أن يكون منزلًا حقيقيًا.
باختصار ، بالنسبة لنا ، فإن العمارة ، التي هي حاوية ، هي أيضًا مكان للتبادل وقبل كل شيء لغة للكشف عن العالم. يعطي الفضاء ديناميكيته ؛ إنه يعطي للعالم رؤيته. كما أنه يعمل على إدخال البشر إلى العالم وتسجيلهم هناك. يعطينا أن نفهم كيف يكون الإنسان أنسنة.
تجعلنا هذه العلاقة الإنسانية بأشياء الحياة ندرك أن المبنى ليس مصممًا لوظيفة واحدة وبيئة واحدة وفترة واحدة. والنتيجة هي أهمية البعد الزمني الذي تحمله العمارة. هذا من شأنه أن يرقى إلى اعتبار العمل المعماري كعمل في عملية التكيف المستمر مع الرغبة في التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
لنقولها بكلمات بسيطة ، مجردة من كل الرتوش ، نحن هناك ، مهندسون معماريون لننقل لعملائنا طاقة التحول ، طاقة العمل المتحرر.